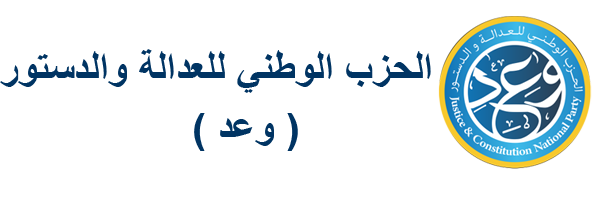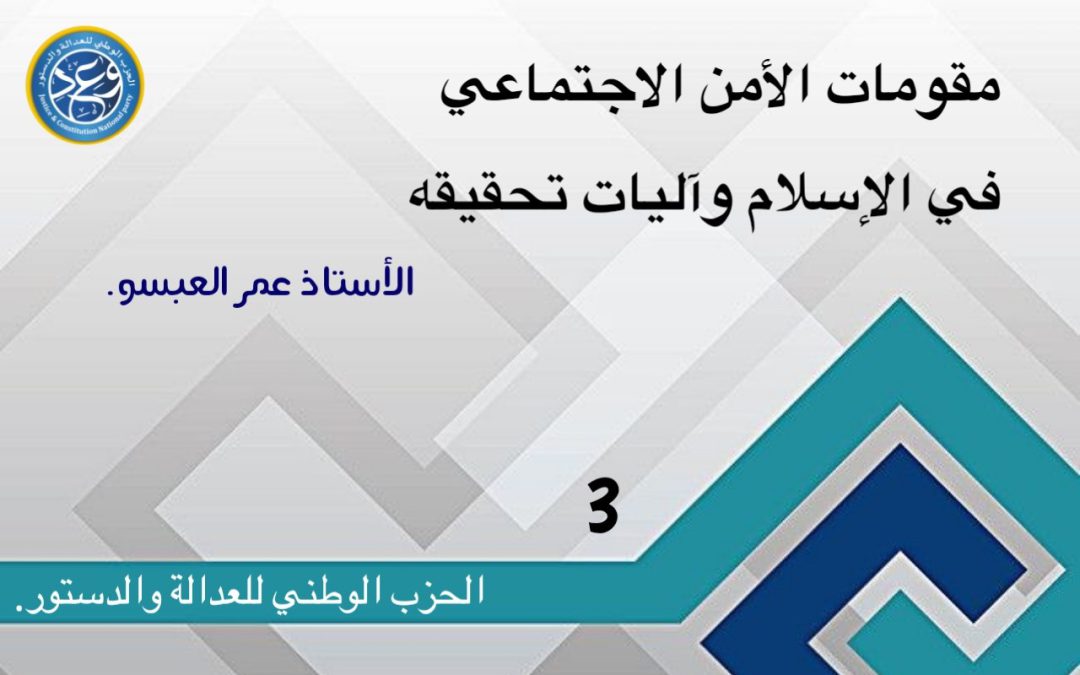تاسعاً: المواطنة:
الانتماء إلى الوطن ركن أساس في الحياة الاجتماعية، بدون هذا الانتماء يصبح الإنسان بدون هوية معلقاً بين السماء والأرض، فالانتماء مسألة ضرورية لتكوين العلاقات الحميمة بين أبناء المجتمع الواحد.
وينشأ من الانتماء إلى الوطن شعور غامر بأن الوطن هو بيته وداره وانه مسؤول عن سلامته وأمنه ورفاهيته وديموميته، عندما يتولد هذا الانتماء يصبح الفرد جزءا من الكل، وانه لبنة في بناء كبير ويترتب على هذه المشاعر مسؤوليات ازاء الوطن ومن يعيش على أرضه. فيتمنى أن يرى وطنه بأبهى صورة من جمال الطبيعة وجمال المدن والمرافق العامة والمباني.
يتوقع أن يرى أبناء وطنه على أفضل صورة وهم يمارسون حياتهم الطبيعية بشوق ولهفة ويتوقع أن يرى سواح بلاده وهم يحملون أفضل الانطباع عن وطنه بعد زيارتهم له وعودتهم إلى بلدانهم.
ويتوقع أن يرى وطنه نظيفاً سليماً من الجهل والمرض تنتشر فيه المدارس والجامعات وتعمه المراكز الصحية من مستشفيات ومصحات.
يتوقع أن يرى وطنه وقد أصبح في مصاف البلدان الراقية والمتطورة اقتصادياً وثقافياً وصحيا، يتمنى أن يضرب وطنه الرقم القياسي في الرخاء الاقتصادي والامن الاجتماعي والتقدم العمراني والسلامة الصحية والرقي الثقافي ويُرافق جميع هذه التوقعات والتمنيات عمل جاد يقوم به كل فرد في المجتمع حسب امكاناته والأدوار التي يقوم بها.
من هنا كان من الضروري على المربين والمرشدين أن يخلقوا المشاعر الوطنية في نفوس ابناء الوطن منذ الصغر حتى تنموا هذه المشاعر مع نموهم الفسيولوجي.
فتنمية هذه المشاعر هي مسؤولية دينية ووطنية وهي مسؤولية كل من يريد الأمن والاستقلال والاستقرار للبلاد وكل من يريد ابعاد الوطن عن شبح الصراعات والمعارك الداخلية التي تنجم عن انتماءات وهمية تتحول إلى انتماءات مؤثرة ومحركة لفصائل المجتمع. وهكذا عندما تطغى الانتماءات الثانوية على الانتماء الحقيقي للوطن تبدأ الازمات وتنتشر الخرقات فتنهار الأسس والضوابط التي يقوم عليها بناء الدولة والأمة، فيتبدد كل أمل بالأمن والسلام والاستقرار.
عاشراً: الغذاء لكل فم:
ضمان الحاجة إلى الغذاء هو ركن آخر من أركان الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي، فالبلدان التي تعاني من الفقر والفاقة هي البلدان التي تشهد الاضطرابات بينما البلدان الغنية هي أكثر استقراراً وأمناً، وهذا لايعني انعدام الحوادث فيها، ربما تأتي بعض الأزمات بسبب الغنى سيما إذا اضطربت المعايير الأخلاقية في المجتمع وسادت الممارسات التي يفرزها الغنى كشرب الخمر وتناول المخدرات وانتشار المافيات. لكن على العموم يمكن لنا أن نقيس تقدم وازدهار واستقرار البلدان إلى عامل الوفرة الغذائية كأحد العوامل المؤثرة في الاقتصاد والرفاه وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في قوله (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
فالعبادة كقيمة معنوية لا يُمكن فرضها إلا في حالة الاستقرار وفي حالة التوازن النفسي والاجتماعي وهذا ما لا يتأتى إلا بخطوتين؛ الأولى: تأمين الجانب الغذائي للبشرية. والثانية: ضمان الأمن وازالة المخاوف.
فالغذاء أولا وقبل كل شيء فقبل أن تُطالب الإنسان بأية مسؤولية لابد من تأمين حاجاته إلى الغذاء. وقد رعى الإسلام هذا الموضوع أشد اهتمام فبالغ في دفع المسلمين إلى الزراعة وتنمية القدرات الانتاجية لتوفير سلة الغذاء للمواطنين، فمن ناحية أخرى كافح البطالة بشتى السُبُل، ومن جانب آخر أعطى ضمانات مالية لكل من هو عاجز عن العمل لأسباب صحية تعيقه عن القيام بأعباء الحياة، وبهذا حل الإسلام أزمة الغذاء وإلى الأبد ممهدا الطريق أمام الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي وكل الأهداف التي يسعى من أجلها المجتمع الإسلامي.
وعند إعادة قراءة المقومات السابقة لا نجد صعوبة في القول إن جميعها تتداخل بشكل وآخر مع هذا العامل وهو توفير الحاجات الغذائية للإنسان.
فالقانون لا يُمكن تطبيقه إلا بإزالة المجاعة من المجتمع.
وتوفير الغذاء، والتكافل الاجتماعي حلقتان متداخلتان، وأساس التعايش هو التعاون الذي يقوم بين أبناء الشعب الواحد في توفير سبل الحياة والعيش الكريم، والتسامح وإشباع الحاجة إلى الطعام عاملان متداخلان أيضاً، والتعاون الاقتصادي أحد أسسه التعاون على توفير المحصول الزراعي سواء بواسطة الزراعة أو التجارة أو الصناعة. والمشاركة السياسية لا يُمكن بلوغها إلا عندما تكون الأفواه مملوءة بالطعام ولا يُمكن تنمية الشعور بالمسؤولية إلا بعد سد حاجات الفرد من الغذاء واللباس والمسكن ورعاية شؤونه الصحية والتعليمية.
والأخوة الإسلامية إذا لم تقم على تلبية المسلم لحاجة أخيه المسلم في كافة الأمور لا فائدة من هذه الأخوة بل ستتحول إلى شعار براق، وأخيراً المواطنة بحاجة إلى عربون لقيام هذا العقد بين الوطن والمواطن وعربونه هو كرم التربة والأرض عندما تدر بالمحاصيل أو المعادن فتصبح هذه الأرض بخيراتها ذات قيمة حياتية للفرد فيقوى انتماؤه إلى هذا التراب، وتالياً تقوى عنده روح المواطنة.
هذه هي المقومات الأساسية التي يقوم عليها الأمن الاجتماعي والتي بدونها تتبدد الآمال بتحقيق الأمن والسلام.
وسائل وآليات الأمن الاجتماعي:
ذكرنا سلفاً ان فكرة الأمن الاجتماعي تقوم أساساً على وجود تلك المقومات وعلى وضع الخطط والمناهج الحكيمة لكن تبقى هناك ضرورة وجود وسائل وآليات تعجل في تحقق الأمن الاجتماعي وهي: القضاء والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وأيضاً شركات التأمين عن الحياة وجميع هذه الوسائل تعمل بعد وجود المقومات السابقة.