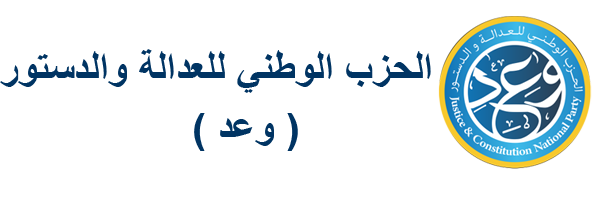وكان(صلى الله عليه وآله وسلم) يكرر كثيراً: (جالسوا الفقراء).
لماذا الفقراء؟!:
لأنهم الطبقة المعدومة التي تحتاج إلى المساعدة بينما تأتي التوصية بالإبتعاد عن مرافقة أهل البدع بأنهم يثيروا الفتن في المجتمع ويدفع به إلى عدم الإستقرار والأمن.
(لاتصاحبوا أهل البدع ولاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم).
فالمعايشة ذات بعدين؛ بعد سلبي وهو كل ما يثير المشاكل في المجتمع وبعد إيجابي بالالتصاق بكل ما يمسك الجماعة ويجعلها كتلة متراصة واحدة والتعايش بهذا المعنى له آثار أخلاقية، فمن آثاره تحمل الآخرين والصبر على اذاهم وقبولهم قبولا حسناً في مختلف الظروف والأحوال في الأحزان والمسرات.
رابعاً: التسامح، ونبذ العنف:
ليس هناك ما يفتح النار على الأمن الاجتماعي مثل العنف واستخدام القوة في حسم الأمور بدلاً من العودة إلى القانون.
وقد انتشر العنف في المجتمعات بسبب انحسار حالة التسامح والتعاطف والتوادد.
أصبح العنف اليوم ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات بالانهيار والإنزلاق إلى حروب وصراعات داخلية، وأمامنا مجتمعات كان الأخ فيها يقتل أخيه بسبب الصراعات العقيدية التي رافقتها ظاهرة العنف، الأمر الذي يستدعي منا وقفة لتأمل هذه الظاهرة لمعرفة أسبابها ونتائجها.
لاشك ان ظاهرة العنف أكثر ما تتفشى في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل والتطرف والذي يؤدي إلى سلب الأحقية عن الآخرين، وهذا هو منشأ التطرف؛ عندما يعتقد أحدنا أنه على حق والآخرين على باطل بدون حجة منطقية ولا دليل عقلي، فيحاول أن يثبت أحقيته من خلال القوة.
فالقوة هي الوسيلة البديلة عن الحوار والإقناع ودحض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، من هنا نشأ العنف في المجتمعات التي يسوده الجهل والتطرف وهذا ما نبذه الإسلام جملة وتفصيلا واستأصل هذه الظاهرة من جذورها فدعى إلى الحوار بدلا من التزمت على الرأي وطالب المسلم بأن يسلم للحق أينما وجده حتى لو كان عند أعدائه.
وأن لا يتكبر على أصحاب الحق وليتواضع لهم، وبهذا المنهج الرصين تمكن الإسلام أنه يقلع جذور التطرف في المجتمع.
ففي الخصال آخر ما وصى به الخضر موسى بن عمران قال له: لاتعير أحدا بذنب، وإن أحب الأمور إلى الله عز وجل ثلاثة: القصد في الجدة والعفو في المقدرة والرفق بعباد الله. وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة.
وبالغ الإسلام في نبذ العنف حتى في النظرة فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله).
أما إذا تطاول عليه ونال منه بما يحزنه فسوف لا تنفعه كلما يقدمه رداً على ما فعله بحقه. قال الرسول الأكرم: (من أحزن مؤمناً ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته ولم يؤجر عليه).
والعنف ينتشر كانتشار النار في الحطب، فهو ينشأ من عمل صغير، ثم يتوسع ويتعمق ويكبر، فكانه لابد من مواجهته في منشاه.
فالعنف يبدأ بيد واحدة فتتكاثر إلى أيادي كثيرة وهذا ما نلاحظه اليوم في المجتمعات التي ينتشر فيها العنف حيث يبدأ صغيراً ويصبح كبيراً لايمكن مقاومته حين ذاك.
وهنا لابد من تتابع منشأ العنف وتطوره في داخل النفس الإنسانية من خلال حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الا أنبأكم بشر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أبغض الناس وأبغضه الناس، ثم قال: ألا انبأكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي لا يقيل عثراً، ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنباً، ثم قال: الا أنبأكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من لا يؤمن شره ولايُرجى خيره).
يضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أيدي الباحثين مراحل تطور العنف في داخل النفس الإنسانية. فالبداية تنشأ من البغضاء فانتشارُها بين الناس يوجبُ عدم التسامح في المجتمع وهو عنف خفيف عندما لايُقيل البعض عثرات البعض الآخر ولايقبل له معذرة ولا يغفر له ذنبا ثم يتطور من عنف خفيف إلى عنف شديد عندما يتحول البغض إلى منبع للشر فلا يؤمن شره ولا يُرجى خيره.
وهو مرحلة يتكامل فيه هذا المرض، ويتأصل في المجتمع ليتحول من مرض نفسي إلى مرض اجتماعي ومن مرض اجتماعي إلى ظاهرة سياسية عندما يستفحل ويتحول إلى حركة ومنظمة، هناك من يُنفذ ومن يؤيد ومن يعين على العنف.
ففي الحديث العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاءٌ ثلاثة..
وهذه هي خصائص الظاهرة الإرهابية المنتشرة اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية.
فقد تحول الإرهاب إلى مؤسسة وجمعية وحركة فهناك من يُمارسه بنفسه، وهناك من يدعمه بالمال والإعلام ومن يقف إلى جانبه ويؤيده وهؤلاء بأجمعهم يشكلون الظاهرة الإرهابية التي نُشاهد نماذج لها في الجماعات والحركات الإرهابية المنتشرة في عالمنا الإسلامي.
والعنف كما هو واضح من أخطر ما يواجهه المجتمع ويسلب منه الأمن والإستقرار وينشر الخوف والهلع بين الناس، فجاءت دعوة الإسلام إلى التسامح إلى إقالة العثرة والزلة وقبول العذر وغفران الذنب. إلى العفو عند المقدرة والرفق بعباد الله وجعل ثمن الرفق بالآخرين الرحمة الإلهية التي تنزل عليه يوم القيامة، بينما جعل جريمة قتل إنسان واحد معادل بقتل أمة يقول تعالى في كتابه العزيز: ((من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
وطالما لم يسفك الرجل دماً حراماً فهو في مأمنٍ من كل شيء فالدم هو النقطة الحمراء التي يجب أن لا يصله الإنسان مهما كلفه ذلك من ثمن.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً).
ونظرة فاحصة إلى المجتمعات التي ينتشر فيها التسامح لانجد للعنف إليها طريقاً وهكذا كان المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام، وعندما انتشر فيه التطرف والفكر الخارجي دب فيه العنف وانتشر فيه الإرهاب إلى يومنا هذا.
خامساً: التعاون الإقتصادي:
اقتصاد أي بلد هو معيار تقدمه وازدهاره واستقراره وأحد مكونات الأمن في المجتمع فعندما يكون الناس متعاونين فيما بينهم لبناء اقتصاد مزدهر تنتعش مفاصل المجتمع ويستتب فيها الأمن فلاتجد من يسلب الآخرين حقوقهم ولاتجد من يحاول أن يستغني على حساب المجتمع. بل تجد الجميع بحركة متصاعدة نحو بناء الإقتصاد سواء كان في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات. فعندما يكون المجتمع متكاتفا روحاً وجسداً تجد كل عضو فيه وهو يكمل عمل العضو الآخر، فالمزارع يزرع في الحقل والتاجر يأخذ محصوله إلى المصنع والعامل يصنع ماتنتجه الأرض وما ينتجه المزارع وهكذا تستمر الحلقة الاقتصادية بصورة مرتبة ودقيقة حاملة معها المجتمع إلى الرقي والاستقرار والأمن وقد حظي التعاون الاقتصادي باهتمام بالغ من قبل النظام الإسلامي فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان اليهم لم يعسروا).
وقال علي بن أبي طالب(رضي الله عنه): (أفضل السخاء أن تكون لمالك متبرعاً وعن مال غيرك متورعاً).
والسعي في قضاء حوائج الناس هو جزء من التعاون الاقتصادي الذي بوجوده ينتعش المجتمع، لأن وجود إنسان محتاج سيكون عالة على الاقتصاد وسيؤدي إلى انهيار الحياة الاقتصادية المرفهة.
لماذا ظلم نفسه وأساء إليها، لأن وجود إنسان محتاج يشكل ثغرة اجتماعية واقتصادية سيكون لها آثارا وخيمة على اقتصاديات المجتمع وبالتالي سيقع تأثيرها على جميع أبناء المجتمع بما فيه الشخص الغني، لأن وجود محتاج بلا سيولة نقدية يعني الجمود الاقتصادي بينما وجود السيولة بيد المحتاج سيحقق حركة في السوق بالتبادل السلعي. فهؤلاء الذين يسعون في قضاء حوائج الناس بتقديم المال لهم سواء عن طريق الهدية أو الصدقة أو القرض سيُساهموا في بناء الحياة الاقتصادية المرفهة.
سادساً: المشاركة:
لاشك ان النظام السياسي القائم على مشاركة أكبر شريحة من أبناء الوطن له دوره المباشر في تنمية الأمن الاجتماعي. فالنظام الذي يقوم على اختيار الأكثرية المطلقة من أبناء الشعب هو الذي يرى مصالح هذه الأكثرية ويوفر مستلزمات سعادتها ورقيها، وهذا النظام أقرب للاستقرار من بقية الانظمة لما يحظى من تأييد شعبي من قطاعات المجتمع، ولما هو موجود من تماسك بين الحكومة والشعب. فالحكومة تؤدي دورها الحافظ لكيان المجتمع، والمحامي المدافع عن حقوق أبناء الوطن، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها تسعى جاهدة إلى التجاوب مع أماني الشعب وتطلعاته وتجسيد أهدافه في الحياة الكريمة وتوفير الحماية الكامله له ولعائلته.
في الوقت نفسه يشعر الفرد المواطن أنه يعيش تحت ظل نظام يسهر على راحته ويُحقق رغباته المشروعة ويمضي قدما في بناء الوطن على أسس رصينة منطلقاً من منافع الشعب لا منافع طائفة أو حزب أو فئة. وعلى هذه الأسس من العلاقة القوية بين الشعب والدولة يقوم نظام الحقوق والواجبات. فللشعب حقوق وواجبات، حقوقه أن يحظى بحماية الدولة ويتساوى أبناؤه، وأن تتوفر له الحرية الكافية لينطلق في اداء واجباته، وهي مساهمة لبناء الوطن من خلال العمل الذي يقوم به سواء في الزراعة أو الصناعة أو الوظيفة، أو أي عمل آخر يقوم به.
يذهب إلى عمله بقلب مطمئن، ونفس راضية تحت غطاء من الحماية والأمن وهذا ما نلاحظه في الحكومات الديمقراطية التي تقوم على مبدأ المشاركة أما الحكومات الإستبدادية التي لايشعر فيها المواطن بأية قيمة إنسانية فلا وجود للآثار التي ذكرناها، لا وجود للحرية الكفيلة ولا وجود للمساواة والعدالة اللتان تشعران الإنسان بأنه محمي من قبل القانون، ولا وجود للعلاقات المتينة بين السلطة والشعب القائمة على مبدأ الحقوق والواجبات، والنتيجة الحاسمة لهذا النظام انعدام الثقة بين الشعب والدولة وانتشار الخوف؛ الخوف من السلطات، الخوف من المستقبل، الخوف على مصير الأبناء. وحصيلة كل ذلك ينعكس على فقدان الأمن الاجتماعي. لذا كان لابد من أخذ مبدأ المشاركة الشعبية في بناء النظام السياسي كمقوم أساسي من مقومات الأمن الاجتماعي.
وقد قام النظام الاسلامي على مبدأ الشورى حيث ورد في الكتاب العزيز ((وأمرهم شورى بينهم)) وأمرهم هنا يشمل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد طبق المسلمون هذا المبدأ في العصور الاسلامية المختلفة محققين أعلى درجات المشاركة الشعبية في بناء السلطة والدولة والقرار السياسي.
ولم يكتف الإسلام بالدعوة إلى المشاركة في بناء السلطة والدولة بل جعل الناس شركاء في الثروة أيضاً، لايحق لأية سلطة مهما كانت قوتها منع المواطن من المشاركة الاقتصادية.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار).
وعندما تكون المشاركة السياسية قائمة على المشاركة الاقتصادية وتوزيع الثروة بصورة عادلة على أبناء الشعب تصبح هذه المشاركة عميقة الجذور، راسخة القواعد لا يمكن أن تلغيها أية قوة أو سلطة، لأن الشعب هنا هو المالك للثروة، وبما يمتلكه يستطيع أن يؤكد إرادته السياسية. وهذا ضمان لاستقرار البلاد وضمان لتوفر الأمن واستتبابه وليست هناك أية قوة قادرة على خرق جداره السميك لأنه متجذر على أرض صلبة وعلى جسور متينة بين الدولة والشعب.
سابعاً: الشعور بالمسؤولية:
قوة الأنظمة تقاس بمقدار ما تستطيع أن توجد لدى رعاياها الشعور بالمسؤولية، فالنظام الذي يتصف أبناؤه بقدر كبير من الشعور بالمسؤولية والنظام القوي القادر على فرض هيمنته على الجميع.
الشعور بالمسؤولية هو الزخم الذي ينتج الطاقة الخلاقة والتي بواسطتها تتمكن من تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فإحساس الإنسان بأنه مسؤول عن بني جنسه الذين يعيشون معه، وانه مسؤول عن الأرض التي يعيش عليها والمناخ الذي يتنفس منه، وانه مسؤول حتى عن الحيوان والجماد يجعله عنصراً إيجابياً للمجتمع يدرك المخاطر التي تهدد أبناء جنسه والأضرار التي تلحق بالأرض والبيئة والحيوان والنبات.
فالإحساس بالمسؤولية يولد لدى الإنسان شعوراً بأن كل شيء من حوله هو مسؤول عنه، هو مسؤول عن الأرض التي يعيش عليها والتي بدونها لايستطيع أن يحيا، كذلك الأمر بالنسبة إلى الهواء والماء والتراب والإنسان والحيوان والنبات وكل شيء. وقد عمل الإسلام على إيجاد هذا الإحساس في الإنسان المسلم. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
هكذا يتبين لنا ان دائرة المسؤولية تتوسع لتشمل حتى البهائم والبقاع وهي الأراضي المتروكة التي تنتظر الإعمار، ويؤكد حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان باعتباره خليفة الله على الأرض ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة).
فالإنسان وبما أنه خليفة الله على الأرض فهو يتحمل مسؤولية كبيرة إزاء ما في الأرض وما عليها وحتى الذي في أعماقها ولايُمكن أداء هذه المسؤولية إلا في ظرف يسوده الأمن والاستقرار ولابد من إيجاد هذا الظرف لتسهل المهمة أمام الإنسانية في عمارة الأرض وإنشاء المدن والحضارات البشرية.
وفوق كل ذلك الإسلام يبني لنا الإنسان المسؤول القادر على تحمل أعباء المسؤوليات الجسام، وهو الذي يتصف كما ورد في حديث المعراج: (كثير حياؤهم قليلٌ حمقهم كثيرٌ نفعهم قليلٌ مكرُهم، الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب، كلامهم موزون محاسبين لأنفسهم متعبيبن لها).
وهم الذين يتحملون أعباء المسؤوليات الجسام عن طيب خاطر حيث ورد: (خير الناس من تحمل مؤونة الناس).
فالمؤمن كتلة من الخيرات، يبادر لعمل الخير بدون إيعاز من أحد: (بادروا بعمل الخير قبل أن تشتغلوا عنه بغيره)، وقال أيضاً: (إن الله يحب من الخير ما يعجل)، فخير البر عاجله، وشعوره بالمسؤولية جعله حساساً إلى ابعد الحدود، يُسارع لعمل الخير قبل الآخرين لايؤجل عمل الخير خشية انشغاله عنه بأمور أخرى.
ومن خصائص الإنسان المسؤول هو الإنفاق فيده مبسوطة بالعطاء لا يتباطأ في تقديم العون لمن يحتاج.
وقد وصف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) هؤلاء: (خير الأيدي المنفقة)، وعندما يقوم هذا النموذج الصالح المسؤول في المجتمع يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعاً خيراً ورسولا للسلام والأمن، ليس فقط على أرض الإسلام بل على جميع البقاع والأقطار.
ثامناً: الأخوة:
الشعور المتبادل بين الفرد والآخر هو أساس التضامن والتماسك في المجتمع أن يوجه المسلم مشاعر الحب والود إلى المسلم الآخر فيعملان معاً على ترسيخ قواعد هذا الحب داخل المجتمع. عندما توجد هذه المشاعر تتولد أحاسيس اجتماعية من قبيل التخوف من الحاق الضرر بأبناء المجتمع، والعمل على توفير الراحة والرفاهية لأبنائه، مثله مثل الأب الذي يحرص على حياة أبنائه يخشى عليهم من ظلمة الليل ومن الريح العاصف ولا يهدأ له بال إلا عندما يُشاهد أبناءه في راحة واستقرار بعيداً عن مواطن الخطر. وهذه المشاعر لن تتكون إلا في إطار الأخوة، عندما يشعر كل فرد في المجتمع بأنه أخ للفرد الآخر. ومساحة الأخوة في الإسلام أوسع من المفهوم المتعارف اجتماعياً، فهو يطلق عبارة الأخ على كل فرد مسلم فكل من ينتمي إلى عقيدته هم أخوة له تتكون بينهم قواسم مشتركة من الحب المتبادل والعمل المشترك والميدان الواحد. بل ذهب الإسلام إلى ما هو أكثر من ذلك فهناك أخوة في النسب وهناك أخوة في الدين وهناك أخوة في الخلق، وقد شبه الإمام الغزالي عقد الأخوة في الإسلام بعقد النكاح بين الزوجين قائلا: (اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين)، ثم يحدد حقوقاً ثمانية للأخوة الإسلامية مستلهماً من الأحاديث والروايات( أن تبدأه بالسلام، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشيعه إذا مات.
والأخوة بهذا المفهوم يضع بين المسلمين واجبات وحقوق. من هذه الحقوق: (من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يُشبع جوعته، وأن يواري عورته، ويُفرج عنهُ كربته، ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده)، وبإزاء هذه الحقوق ليست هناك مشكلة إلا وهي قابلة للحل، وحتى مشاكله بعد مماته سيجد من يحلها ويتصدى لها.
وليست الأخوة فقط القيام بهذه الواجبات وحسب بل هي مشاعر متدفقة تتداخل لتتحول إلى شعور واحد يجمع الكل في إحساس واحد من الأخوة، فالمؤمن يأنس للمؤمن يُجالسه ويُلاطفه يلتجأ إليه عندما تهب عليه المصائب وتحوم حوله المشكلات: (إن المؤمن يسكن إلى المؤمن كما يسكن الضمآن إلى الماء البارد).
الحياة في واقعها مجموعة أزمات ومصائب فعندما تحل بأحد أزمة لا يوجد طريقاً للخلاص إلا في أحضان أخيه المؤمن وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه سبعين كربة من كرب الآخرة)([43]) وفي إطار من الأخوة بنى الإسلام المجتع الإسلامي في المدينة المنورة الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا.
فكم كان بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة، وكم كان بين المكيين وأهل يثرب من أحقاد دفينة اججها اليهود بين هاتين الطائفتين كلها تبخرت مع حلول آصرة الأخوة حتى أصبح الأنصاري أخا للمهاجري يهب له أفضل زوجاته ليختار منهن ما يريد، كما فعل سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجري، فأين تجد هذه الصورة الرائعة من الأخوة، لن تجدها بالطبع إلا في ظل الإسلام الذي بنى المجتمع على قاعدة العقيدة وجعلها أفضل ركائز في التعامل الاجتماعي فقتل المسلم أخاه الكافر الذي أولدته أمه من أجل عقيدة الاسلام. وأمام هذه العقيدة تزول كل الحواجز والثغرات.